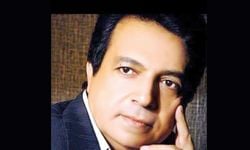زادت فى الآونة الأخيرة التساؤلات حول مشروعية الفلسفة وأهميتها. وتدرجت تلك التساؤلات من مستوى المناقشة «الأكاديمية» الجادة وتدنت حتى وصلت إلى مستوى إشهار سلاح التكفير والترهيب فى وجه من يدافعون عن أحقية الفلسفة فى الوجود. أو التلويح بعدم جدوى الفلسفة إزاء الحاجات المادية المباشرة والأزمة الاقتصادية الطاحنة.
فمن الجانب الأول نرى بعض أصحاب الاتجاهات العلمية المتطرفة من هؤلاء الذين انبهروا بالتقدم العلمى الرهيب الذى يزداد يومًا بعد يوم يخلعون على العلم صفات القداسة والجمود وصوروه على أنه «المقدس» الجديد وراحوا يؤكدون على أن ما عدا العلم من مصادر المعرفة باطل وبلا معنى.. فلقد حل العلم فى نظرهم جميع مشكلات الإنسان ولم يعد الإنسان فى حاجة إلى الفلسفة أو الفن أو الشعر... فكل هذه فى نظرهم من مخلفات الماضى وإذا بقى للفلسفة من دور فدورها أصبح لدى أصحاب الوضعية المنطقية مثلا ينحصر فى تحليل قضايا العلم بشقيها التحليلى والتركيبى من حيث المبنى والمعنى، ومن جهة اللغة والمنطق وليس من حق الفلسفة أن تقول أو تضيف من عندها شيئا أو تتحدث عن الوجود والعالم أو الإنسان ويكفيها فقط مهمة التحليل المنطقى.
ولا يخفى على أحد من دارسى الفلسفة مدى تهافت وضحالة مثل هذا الموقف الرافض للفلسفة الساعى إلى اغتيالها وحصرها فى تلك الزاوية الضيقة من زوايا المعرفة. وبداية نقول إن المقارنة بيـن الفلسفة والعلم مقارنة ظالمة فى أساسها لأن للعلم مناهجه وأدواته الخاصة التى تتقدم يومًا بعد يوم وبرغم هذا فإن نتائج العلم ليست مطلقة بل هى نسبية فما يصل إليه العلماء ليس هو كل الحقيقة. أما المنهج الفلسفى فهو منهج عقلى فى أساسه، والاختلاف بين فيلسوف وآخر هو فى طريقة فهم هذا المنهج وتوظيفه فهناك من يقف عند حد المنطق «الأرسطي» الصورى، وهؤلاء هم المذهبيون... وهناك من يثور على هذا المنطق الجامد ويستبدل به المنطق الجدلى التطورى. وتاريخ الفلسفة هو تاريخ الصراع بين القائلين بالسكون والجمود والهوية وبين القائلين بالتغير والحركة والتناقض والثورة.
أضف إلى ذلك أنه برغم النتائج العظيمة والهائلة التى وصل إليها العلم فإن العلم لم ينقذ بعد الإنسان وما زالت هناك مناطق مظلمة على وجه الحقيقة لم يستطع العلم أن يصل إليها بعد وهناك مشكلات أو لنقل هموم لم يستطع العلم أن يجعلها ضمن أبحاثه وتجاربه مثل: قضية المصير.. الحرية الإنسانية.. القلق.. الاغتراب أو الضياع الإنسانى.. مسألة معقولية أو لا معقولية هذا العالم فكلها مشكلات لا يستطيع فيها العلم أن يقول كلمته الأخيرة إنما تبقى الكلمة الأخيرة فى مثل هذه المشكلات للفلسفة وللفلسفة وحدها. ثم إننا لا ننسى أن العلم غالبًا ما يرتبط بما هو قائم.. بما هو متعين وموجود فى عالم الواقع. أما الفلسفة فهى تنزع دائمًا إلى المثال.. إلى ما ينبغى أن يكون، والإنسان وتر مشدود بين نقطتين إحداهما الواقعية والأخرى المثالية. فهو مرتبط بما هو قائم لكنه فى نفس الوقت يهفو إلى معانقة المستحيل الممكن... يهفو إلى تجاوز ما هو قائم. بل أحيانًا سلب ما هو قائم.. سلب الناقص المشوه من أجل تأسيس الكامل الجمالى وإذا كان العلم والفلسفة طريقين للمعرفة فلماذا نتصور أن هناك قطيعة بينهما أو أن أحدهما يخضع للآخر.. إننا نرى فى هؤلاء الذين لا يتصورون الفلسفة إلا خاضعة للعلم إنما يعانون من نزعة تسلطية واضحة لا تتصور الأشياء إلا من خلال مقولتى العبد والسيد أو المتسلط والخاضع وهى علاقة غير سوية ويجب أن يستبدل بها نوع من الاقتناع بأحقية أن تمارس الفلسفة دورها المعرفى جنبا إلى جنب مع العلم ما دام كلاهما ضربًا من ضروب المعرفة. بل لا حرج فى أن تستفيد الفلسفة من نتائج العلوم وأن يستفيد العلماء من تأملات الفلاسفة. وهناك مشكلات داخل العلم نفسه لا يستطيع العلماء مناقشتها وإلا تحولوا إلى فلاسفة مثل: مشكلة المنهج... والحقيقة ومسلمات العلم كالحتمية والعلية والاستقراء.. وغيرها.وهناك أيضا مشكلات تقع على التخوم بين الفلسفة والعلم كمشكلة اغتراب العلم وهى تعد من المشكلات الحيوية التى تطرح نفسها على بساط البحث الفلسفى. فكثير من نتائج العلم بدلًا من أن تكون خاضعة للإنسان أصبحت تقف ضده ويخضع لها بدلًا من أن تخضع له وهذا ما يُسميه فلاسفة الوجودية «بالاغتراب التكنولوجي».
إن التقدم العلمى الكبير لم يستطع أن يقدم للإنسان جميع الحلول ولم يصنع لنا بعد الفردوس الأرضى المفقود، فالحقيقة ليست حكرًا على العلماء أو الفلاسفة وحدهم وإنما هى ملك للجميع. ملك لكل هؤلاء الذين يجربون أو يفكرون أو يحلمون. ومن يحاولون جعل الحقيقة قاصرة على العلم وحده إنما يقعون ضحية نظرة ضيقة أحادية الجانب ليست فى نهاية الأمر فى صالح الإنسان.
وللحديث بقية